رضوى عاشور، 2010
تحذير: هذا المقال يحتوي على معلومات عن القصة ونهايتها

اليوم سنقف أمام البحر من جديد. لكننا لن نشقّ مياه الأطلنطيّ متخفين على متن تايتانيك. لن نبحر شمالًا بحثًا عن وحش فرانكنشتاين. لن نقف مع أسرة طرزان المذعورة على ساحلٍ الأدغال الإفريقية الموحش لنتأمل السفينة المبتعدة. نعم، اليوم سنقف أمام البحر من جديد. ولكنّ شاطئ الأبيض المتوسط سيكون حدّنا.
لطالما حاولنا أن نمحو الحدّ الفاصل بين عالم القصة وعالمنا، أن ننغمس في القصة لدقائق ننحّي فيها كلّ شيءٍ جانبًا قبل أن نعود إلى واقعنا. أما اليوم، فسنتوقف كلّ لحظةٍ كي نتذكر، عنوةً، أننا نقرأ قصة، نناقش مهارة الكاتبة، نحلل أدواتها، ولكننا لن نتعمق أكثر من ذلك. ليس اليوم. لأن قصة اليوم ليست مجرد قصة. ولأنها لم تنته بعد.
عند شاطئ المتوسط تبدأ رقية، بطلة القصة، حكايتها. تقارن بين شاطئ المتوسط الذي زارته في الأسكندرية وبيروت، وشاطئ المتوسط في الطنطورة، وهي القرية الفلسطينية التي ولدت رقية ونشأت فيها. صحيحٌ أنّها شطآن لنفس البحر، ولكن شتان بين شاطئ المدينة الذي يفصلك فيه سورٌ عن البحر، فتعدّ له العدّة وتنزله كالضيوف، وبحر الطنطورة، الذي كان يلتحم بحياة أهل القرية تمامًا، لدرجة أن رقية لا تتذكر متى تعلمت السباحة لأنها لا تتذكر متى تعلمت المشي ولا الكلام.
بهذه المقارنة البسيطة تضع الكاتبة حجر الأساس الذي ستبني عليه الرواية كلّها. فنلمح جانبًا من أسلوب رقية المميز، ونستعدّ لنتعرف على محطات حياتها في مدنٍ متفرقةٍ نشعر أنّها لم تكن سعيدةً فيها تمامًا، لأننا نراها مشتاقةً إلى بحر البلد، تبحث عنه في الأسكندرية وبيروت، وتعقد المقارنات، فلا تجده.

ثم تنتقل رقية إلى قصة إعجابها بشابٍّ من عين غزال وهي في مشارف الصبا، واعتراض والدتها على عقد الخطبة لأنّها لا تريد أن تغرب ابنتها في حيفا، التي لا تبعد عنهم في واقع الأمر إلا عشرين كيلومترًا، لكنّها لم تكن قد غادرت القرية قط، فبدا لها الأمر أشبه بـ«رحلة السندباد في بلاد الواق الواق» كما تخبرنا الكاتبة.
تقصّ علينا رقية تفاصيل عشوائيةً متناثرة في ظاهرها، ولكنّها تسرب إلينا بسلاسةٍ بالغةٍ مظاهر حياة البلد وأهلها وقيمهم وعاداتهم، وحتى أناشيدهم ورقصاتهم وأكلاتهم، دون أن تفرد لذلك فقرةً أو تسلط عليه الضوء. بل تتشابك كلّ الخيوط في حكايتها وتتعقد وتتداخل حتى لا نكاد ندرك أين بدأ خيطٌ وأين انتهى آخر، لكننا نجد أنفسنا فجأةً أمام نسيجٍ قصصيٍّ متقنٍ محكمٍ، يدمجنا في أجواء قريةٍ تقليديةٍ صغيرةٍ في منتصف القرن الماضي، لا تبدو غريبةً عنا تمامًا وإن كانت ليست مألوفةً تماما في الآن ذاته.
بمجرد أن نندمج في واقعة خطبة رقية، وخوف الأمّ من ركوب القطار ومن أن تغرب ابنتها في حيفا، تقطع رقية علينا الطريق بنبوءتها الحاسمة: لن تذهب الفتاة إلى حيفا، ولن تركب الأمّ القطار أبدًا. ورغم أنّ في النبوءة ما يوافق هوى الأمّ، لا يشعر القارئ بالراحة أو السعادة من أجلها، بل يشعر أنها نبوءةٌ مقبضة، تحفر بها الكاتبة البارعة مواضع النصال التي ستغرسها في قلب القارئ بعد قليل.
ثمّ تخبرنا رقية بأنها اعتادت أن تحكي كلّ هذا لأحفادها. لقد صارت جدةً إذن! لكن هل تزوجت ابن عين غزال؟ لا تتفضل علينا رقية بالمعلومات. بل تجعلنا نجمع أجزاء الصورة من خلال مشاهد صغيرةٍ متناثرةٍ، مثل تلك القصة التي تحكيها رقية لأحفادها عن المرة التي ضربتها فيها أمّها وهي صغيرةٌ لأنّها طلبت من بنات الغجر أن يدقوا لها وشمًا، ثم تذكر لنا امتعاض حفيدها المقيم في كندا ونقده لعنصرية أمّ رقية التي رفضت ثقافة الغجر، وارتكبت جرم ضرب الأطفال أيضًا. تنفجر رقية ضاحكةً ضحكةً لا تمت للمرح بصلة أمام هذه المفارقة الحية بين عصرٍ وعصر وهي تترحم على أمّها وعلى زمان أمّها. ثم تنتهي الإجازة ويغادر الأولاد والأحفاد إلى البلاد التي يقيمون فيها. الآن وهي تقف على شاطئ مدينةٍ تبعد مئات الكيلومترات عن الطنطورة وعن حيفا، وقد ودعت أبناءها وأحفادها في المطار، تستحضر رقية وجه أمّها المذعور وصوتها المستنكر وهي تسأل زوجها ما إذا كان مستعدًا ليغرب ابنته في حيفا.
ثم تترك رقية كلّ ذلك، وتستهل فصلًا جديدًا بوصفٍ شعريٍّ للربيع في الطنطورة، ولشجر اللوز الذي كانت أزهاره تسرق الأضواء حتى من البحر نفسه، وتخلب لبّ الأطفال الذين لا يطيقون صبرًا فيقطفون ثماره وهو لا يزال أخضر. تسمح لنا رقية أخيرًا أن نغرق في صورةٍ من النوستالجيا الدافئة الرائعة المبهجة، ثم تلقي بسؤالٍ بسيط:
❞فلماذا اختاروا هذه الشهور الأربعة للحرب والضرب وقتل ما لا يحصى من عباد؟ ❝
ولو أنها بدأت مباشرةً بوصف الدمار أو بنبوءةٍ من نبوءاتها المقتضبة، لما كان لها نفس الأثر الصادم الذي خلّفه السؤال المباشر بعد صفحةٍ كاملةٍ من التفاصيل الدافئة.
لم تدرك رقية كلّ ما حدث لأنّها كانت صغيرة، ولكنّها تصف لنا حالة التوتر العام والشعور بأنّ الهواء كان على وشك، وإن كانت لا تعرف على وشك ماذا بالضبط. ثم جاءت أخبار التقسيم وإعلان دولة إسرائيل، وبدأ التصدع. والتصدع هنا ليس سياسيًّا فحسب. فنحن نراه في تفاصيل مثل أنّه لم يعد هناك فرقٌ بين الرجال والنساء في تناقل الأخبار والحديث عن شراء السلاح، فتقسيم المسؤوليات والأدوار الاجتماعية صار رفاهيةً لا تحتمل في ظلّ الظروف القاهرة الجديدة. نرى التصدع في أول صفعةٍ تتلقاها أمّ رقية من زوجها الذي طالما كان رجلًا طيبًا حنونًا، لكنه صار “حقل ألغامٍ” ينفجر في وجه أهل بيته كما تصف لنا رقية. نرى التصدع في انقطاع العلاقة بين والد رقية وشقيقه الذي كان أقرب الناس إليه بسبب خلافهما حول التصرف السليم حيال التقسيم: البقاء أم الرحيل.
ثمّ تسود أجواءٌ من الحماس والأمل البلدة مع أنباء دخول الجيوش العربية فلسطين. تصف لنا رقية كيف ارتفعت آمال الجميع حتى جاوزت أعلى سقف، فمصر عبرت من رفح، سوريا دخلت من جنوب بحيرة طبريا، لبنان عند رأس الناقورة، الأردن عبرت من جسر الشيخ حسين… صار أهل القرية جنرالاتٍ يناقشون كيف سينتصر العرب، كيف سيتقدمون، كيف سيطبقون على العدوّ كالكماشة، لينقذوا فلسطين… هل تشعر بالغصّة في حلقك بعد، عزيزي القارئ؟
بعد موجاتٍ متعاقبةٍ من الأمل واليأس، يأتي الخبر اليقين. تحكي لنا رقية عن الليلة المشؤومة التي صارت في نهايتها واحدةً من اللاجئين الذين كانت تشفق عليهم، ويحاكي الارتباك الذي يشعر به القارئ التجربة التي عاشتها رقية، لأننا -مثلها تمامًا- لا ندرك تمامًا ما يحدث إلا متأخرًا. تغرقنا الكاتبة بتفاصيل ليلة التهجير الحسيّة حتى تقحمنا إقحامًا في المشهد القاسي. تنثر لنا بين السطور كلماتٍ عن أصوات الليلة المشؤومة ومشاهدها وألوانها وملمس ما تحمله رقية ووزنه والرائحة الخانقة الغامضة التي كانت تملأ الجو، فنرى ونسمع ونشمّ رغمًا عنا. ويزداد شعورنا بالانقباض عندما يختفي الرجال فجأةً من الصورة، ونجد الأمّ المسالمة البسيطة وقد تحولت إلى جنرالٍ حازمٍ يلقي بأوامر قاطعةً وهي تحمل مفتاح الدار وتغادر مع الصغار، إلى أين؟ لا نعرف، وهي أيضًا لم تكن تعرف.
نفيق من كلّ هذا على صوت صراخ رقية إذ شهدت جثث أبيها وأخويها وابن خالها على أحد أكوام الجثث. ورغم ما يثيره المشهد من حزنٍ طبيعيٍّ في نفس القارئ، يظلّ ردّ فعل الأمّ التي انخرطت في البكاء على ابن أخيها فقط دون غيره أكثر إثارةً للألم والمرارة. لأنّها في اللحظة التي رأت فيها جثث زوجها وابنيها صور لها عقلها أنهم فروا إلى مصر ولم يقتلوا مع من قتل، وهي حيلةٌ دفاعيةٌ نفسيةٌ صاحبتها حتى الممات رغم كلّ الدلائل التي كانت تشير إلى الحقيقة.
عندما تحكي لنا رقية ذكرياتها عن هذه اللحظات الفارقة، تعود لتتنقل بين صيغة المستقبل وصيغة الماضي في الحكاية؛ فتخبرنا بعدما وصفت مشهد تحميل النساء والأطفال في الشاحنة استعدادًا لطردهم خارج البلد:
❞ستنزلنا الشاحنة في الفريديس، وسنتوزع في بيوت الخلق ❝
ثم تعود إلى قصّ الأحداث بصيغة الماضي التقريرية. وهي تقنيةٌ بارعة متكررةٌ في الرواية، لها مذاق النبوءة المقبضة، وإن كانت نبوءةً بأثرٍ رجعيّ، وهي تبرز الأحداث التي تودّ الكاتبة أن يركز القارئ عليها أكثر من غيرها لما لها من أثرٍ فيما يلي من أحداث، ولما لها من آثارٍ باقيةٍ في نفس رقية. كما أنّ استخدام صيغة المستقبل في هذه المواضع يحمل شيئًا من الانفصال المقصود عن الواقع، فنرى رقية أحيانًا تعمد للإشارة إلى نفسها في تلك المواضع بالـ”فتاة”، وكأنها تروي أحداثًا عن فتاةٍ غريبةٍ لا تمتّ لها بصلة.
تقفز رقية في حكايتها من نقطةٍ إلى نقطةٍ، فلا تلتزم بخطٍّ زمنيٍّ أو مكانيٍّ مرتّب، فتترك القارئ في حالةٍ من الترقب المستمر. تلقي في وجوهنا بقطع البازل وتترك لنا مهمة تركيبها، لأنّها لا تتحمل أن تركب الصورةّ فتراها كاملة. تحدثنا عن أحفادها قبل أن نعرف أنّ لها أبناء، وتنتقل باستمرارٍ في حكاياتها من الأسكندرية إلى الطنطورة إلى لبنان إلى الإمارات دون سابق إنذار.

ولا يملك القارئ إلا أن يستغرب الفرق الشاسع في درجات حرارة الحكاية التي ترويها رقية. تحدثنا وهي جدةٌ عجوزٌ في السبعين عن أيامها كطفلةٍ في الطنطورة بحيويةٍ وتفصيلٍ وحرارةٍ، ثم تحدثنا عن حياتها كزوجةٍ وأمٍّ وجدةٍ بصورةٍ ضبابيةٍ، وكأنّها تحكي عن شخصٍ آخر عاش في زمنٍ بعيدٍ ومكانٍ بعيدٍ. وكأنّ حياتها الحقيقية قد توقفت يوم هجّرت من البلد، وكأنّ كلّ ما جاء بعد ذلك كان خواءً. تؤكد لنا رقية نفسها ذلك حين تخبرنا أنّها منذ اليوم الذي أركبوهم فيه الشاحنة ورأت كوم الجثث بقت هناك لا تتحرك، وإن بدا غير ذلك. ثم تستطرد قائلة:
❞أستغرب. أتساءل. ما الذي تفعله امرأةٌ تشعر أنها بالصدفة، بالصدفة المحضة، بقيت على قيد الحياة؟ تعي ضمنًا أو صراحةً أنها عارية من المنطق، لاستحالة إيجاد أية علاقة بين السبب والنتيجة، أو للدقة استحالة فهم الأسباب حين تتساقط على رأسها نتائج لا تفهم نتائج ماذا، ولم تفعل أي شيء ولم تع بعد أي شيء، لا ﻷنها صغيرة فحسب، بل ﻷن وقوع السقف على رأسها كان نقطة البداية، فلماذا سقط السقف في الأول لا الآخر؟ ماذا تفعل؟ كيف تتعامل مع الدنيا؟ ❝
وربما تظنّ أنّها تتحدث عن صدمتها الأولية حين هجرت من بلدها إلى لبنان، ولكنّها تباغتنا كعادتها بسؤالٍ يجعلنا نعيد النظر في الخيط الزمانيّ للحكاية، تسأل:
❞هل كنت أعي كل هذه الأمور وأنا أخرج من تحت الأنقاض؟ ❝
ثم تتركنا من جديد دون توضيحٍ كالعادة، فلا تفصح لنا عن طبيعة هذه الأنقاض التي دخلت القصة فجأةً دون استئذانٍ إلا بعد صفحاتٍ كثيرةٍ في موضعٍ آخر. وكأنّها كلّما تذكرت شيئًا أوقفت نفسها عن الاسترسال في تذكّره، فلا تعود إليه إلا بعد حين، عندما تجد نفسها مضطرةً إلى الهروب مؤقتًا من شبح ذكرى أخرى.
ولكننا ندرك في هذه اللحظة أن الأنقاض، القصف، الخطر الدائم، الانقلابات المفاجئة، الركض الغريزيّ المحموم طلبًا للحياة بينما كلّ ما تتمناه حقًّا هو الموت، ندرك أنّ كلّ ذلك جزءٌ ثابتٌ من عالم رقية. لم تتعرض رقية لصدمةٍ واحدةٍ قلبت حياتها رأسًا على عقبٍ لتستقرّ بعدها في حياةٍ جديدةٍ تسترجع فيها الماضي وتحلّله وتهضمه إلى أن تستقرّ في واقعها الجديد، كالبطل الرياضيّ الذي يتعرض لحادثٍ يقعده، أو الشخص الذي يفقد عزيزًا بصورةٍ مفاجئة، وهي أحداثٌ كبيرةٌ صادمةٌ يعقبها حياةٌ كاملةٌ لاستيعاب الحدث والتعايش معه. أما رقية، فقد كانت صدمة التهجير أول القصيدة فحسب، ولم تتوقف الصدمات بعدها قط. وكانت كلّ صدمةٍ جديدةٍ تشكل طبقةً عازلةً إضافيةً تخدر مشاعرها وتفصلها نفسيًّا عن الواقع كي تستطيع مواصلة الحياة بأيّ صورة.
ومن صميم مأساة رقية أنّها تبحث حولها باستمرارٍ عن أيّ شبحٍ لحياتها الآمنة القديمة في الطنطورة، لتسترجع شيئًا من حلاوة الماضي تعينها على الاستمرار. ولكنّها كلما استرجعت ذكرى الدار استرجعت واقعة سلبه منها، وكلما استحضرت ذكرى أبيها وأخويها صاحبت الذكرى صورة جثثهم على الكوم. فأنّى لها أن تتجاوز التجربة؟
نرى ذلك واضحًا في انجذابها الدائم إلى ختيارات المخيم، أي النسوة العجائز، كذبابةٍ تنجذب مسحورةً بضوء مصباحٍ ساطعٍ في ليلةٍ مظلمة. كانت تذهب إلى عجائز المخيم لتطلب حكاياتهم ولا تملّها أبدًا، كالطفل الصغير الذي يطلب من أمّه كلّ ليلةٍ أن تحكي له نفس الحكاية لا يريد عنها بديلًا، تأسرها حكاياتهن التي تبدأ دائمًا بـ«هناك، وما حدث حين استحلوا البلد وأطلعونا فشردنا إلى لبنان». وهي حكاياتٌ يتطابق هيكلها وإن اختلفت تفاصيلها، تشترك كلّها في القسوة المفزعة التي تقترب من العبثية. ولكنّها -رغم ذلك- الشيء الوحيد الذي تألفه رقية، الشيء الوحيد الذي يشعرها أنّها تعيش الواقع الآن وهنا، لا هناك في الشاحنة تتأمل كوم الجثث.
ثمّ إنّ رقية لا تستطيع أن تفصل الكابوس العام عن كابوسها الخاص، فنراها تتساءل عن جدوى رفع قضيةٍ أمام المحكمة الدولية ضدّ الجرائم الإسرائيلية، طالما لن تعيد القضية القتيل إلى الحياة. ثم تسترسل في تساؤلاتها عما إذا كانت القضية ستعيد للقتيل روحه فيقوم من قبره ويمدّ يده ليمسك بيد أخته الصغيرة ويبتسم، ونعرف عندها أن ما بدأ حديثًا عامًّا عن كارثة فلسطين كلّها قادها إلى ذكرى جثتي أخويها على الكوم، وأنّها لا تستطيع فصل العامّ عن الخاصّ، لاستحالة فصل العامّ عن الخاصّ.
تتضاعف العبثية المريرة مع تصاعد الأحداث. وإن كانت اعتداءات العدوّ وخناجره قد آلمتك، فانتظر حتى ترى القهر يتسرب من بين السطور التي تصف الخناجر الصديقة: حصار أمل لمخيم اللاجئين، مذبحة تلّ الزعتر، كابوس صابرا وشاتيلا ومجزرة مستشفى عكا التي كان زوج رقية من ضحاياها، مجزرة الخليل، مذبحة قانا، وغيرها. تحكي لنا رقية عن الصمت المهيب عند إذاعة خطب جمال عبد الناصر، كيف كانوا يخرجون مفاتيح الدور ويستعدون ليوم العودة. ثم تحكي عن زلزلة الأرض تحت الجميع في نكسة 1967. كم عامًا يجب أن يمرّ قبل أن تفقد نكسةٌ كهذه مرارتها في قلوب جيلي الذي لم يكن قد ولد بعد حينها حتى؟ كيف مرت على هؤلاء الذين عاصروها إذن؟ كيف مرت على هؤلاء الذين علّقوا مصائرهم عليها؟
لا تسرف شخصيات القصة في الحديث عن مآسيها. يصرّ الجميع على الانخراط في الحياة الجديدة رغم التفاصيل التي تصرخ في وجههم أن لا مرحبًا بكم هنا. ومع تصاعد العنف، تذهب رقية مع ابنتها بالتبني مريم إلى الأسكندرية فرارًا مما يواجهه الفلسطينيون في لبنان. تندمج مريم في حياة الجامعة وتتشرب اللهجة المصرية وتزداد سحرًا، لكنّ رقية لا تجد نفسها في الأسكندرية كما لم تجد نفسها في الإمارات أيضًا قبل ذلك، تستثقل النزهات السياحية التي تتحمس لها مريم في مصر. وعندما تتمكن أخيرًا من العودة إلى صيدا، إلى أقرب مكانٍ يربطها بالوطن، تصطحب مريم إلى سوق النجارين، وسوق الكندرجيّة، وسوق العطارين، ولا تستثقل ذلك أو تلاحظ أنّه لا فارق بينه وبين رحلات مريم السياحية الصغيرة في مصر.
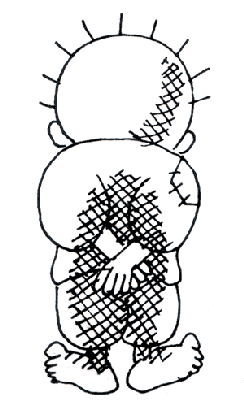
رغم كلّ شيء، تأتي الخاتمة أبعد ما يكون عن اليأس. قبيل النهاية، تذهب رقية ضمن مجموعةٍ من أهالي المخيمات لزيارة فلسطين. وهم لا يستطيعون دخول أرض فلسطين نفسها، ولكنهم يقفون على الجانب الآخر من السلك الشائك الفاصل بين لبنان وفلسطين. ومظاهر الفرح في المشهد لها مذاقٌ مر. فكلّ هذه الفرحة، كلّ هذه الاحتفالات والأطعمة والبلالين وأقفاص الحمام، كلّ هذا فقط لأنهم يرون أرضهم المسلوبة وبعضًا من أهلهم من وراء سلكٍ شائك. فأي قهر؟ أي ذل؟
تتفاجأ رقية عندما ترى أحد أبنائها ضمن الأهالي على الجانب الآخر، وكانت تظنّه في كندا في ذلك الوقت. وكانت معه رضيعته التي لم تكن رقية قد رأتها من قبل. في المشهد قبل الختامي، ينقل الأهالي حفيدة رقية الرضيعة من فوق السلك الشائك كي تضمّها جدتها، ويخبرها ابنها أنه أطلق عليها اسم رقية أيضًا. وتبلغ الرمزية في الرواية أوجها عندما لا تجد رقية الكبيرة هديةً مناسبةً لحفيدتها في هذه اللحظة سوى مفتاح الدار القديم الذي ورثته عن أمّها، فتنزع الحبل الذي علّقت فيه المفتاح من على عنقها وتًلبسه للصغيرة، قبل أن تعيدها إلى والدها وهي توصيه بالحفاظ على المفتاح. ولا يتساءل أحدٌ من الواقفين عن جدوى مفتاح الدار بعد أن هدمت الدار والقرية كلّها ليقوم في مكانها منتجعٌ سياحيٌّ إسرائيليّ. لا يتساءل أحدٌ عن كلّ هذا، بل يسود جوٌّ من الصمت المتفهم. لأن ملاك الأمر كلّه ليس في الدار التي تهدمت، ولا في المفتاح القديم الصدئ الذي لن يكتب له أن يفتح بابًا ثانيةً أبدًا، بل فيما يرمز إليه ذلك المفتاح، وما يرمز إليه أن تنمو رقية جديدةٌ تحمل نفس المفتاح الذي حملته جدتها وأمّ جدتها من قبلها، كي لا يفارقها ذلك الدليل الملموس أنّ الأرض أرضها، والتاريخ تاريخها، وأهل البلاد أهلها.

الإتقان والبساطة الخادعة هما البطل الحقيقي لرواية الطنطورية. ورقية اختيارٌ موفقٌ للغاية لرواية القصة، فلو كان الراوي رجلًا لركز على الخلافات والتفاصيل السياسية والعملية، ولو كانت امرأةً لركزت على انقلاب أحوال الأسر والفقد وتغير طباع الرجال. أما رقية، فقد كانت طفلةً لماحةً في سنوات مراهقتها الأولى، ولذلك فانطباعاتها عن التقسيم والاستيطان هي انطباعات طفلةٍ تحكيها لنا بعد أن صارت جدةً عجوزًا أعادت التفكير في سيناريو طفولتها هذا آلاف المرات. بالإضافة إلى أنّها لم تكن معزولةً عن عالم الرجال تمامًا بعد مثل النساء الكبار، فكانت تنقل لهم الشاي في مجالسهم، وتجلس معهم أحيانًا، وتسمع أطرافًا من أحاديثهم. وكانت منخرطةً أيضًا في عالم النساء الكبار بطبيعة الحال، ولذلك كانت أقدر من أي رجلٍ أو امرأةٍ على الاطلاع على طيفٍ واسعٍ من المواقف والآراء ونقلها إلينا. وقد أتاح لنا هذا استراق نظرةٍ قريبةٍ على بعض ما خبره أهل البلاد في تلك الفترة العصيبة، وترجمة ما عناه التقسيم والاستيطان في إطار حياتهم اليومية، بعيدًا عن التغطيات الإخبارية الدامية، أو تسييس القضية أو وضعها في إطارٍ أكاديمي.
ورقية شخصيةٌ ثلاثية الأبعاد، نكاد نشعر بأنفاسها تتردد بين الصفحات. لها أسلوبٌ مميزٌ في الحكاية، وكثيرًا ما تتحدث في شبه جملٍ قصيرة متقطعةٍ من كلمتين أو ثلاث، دون رابطٍ أو حرف عطفٍ يربط بينها. وهذا التقطيع يترك أثرًا في نفس القارئ، ويعكس حالة رقية التي لا تكاد تبدأ الكلام حتى تتمنى أن تسكت، والتي تتجنب الربط بين أحداث حياتها قدر استطاعتها، كي لا تجن.
ومن اختيارات الكاتبة الموفقة الأخرى، أن جعلت رقية من المحظوظين الذين لم يضطروا إلى العيش داخل المخيمات، ولم يعانوا من الأزمات المادية، وإن نقلت لنا رقية من خلال حكاياتها بعضًا من قصص هؤلاء الذين عانوا من الأمرين. وهو قرارٌ أدبيٌّ خدم الهدف الأصليّ من الرواية، لأنه جعلنا نركز في الأزمة الأساسية الأم، وكيف أنّه حتى وفرة المال أو العلاقات الاجتماعية الواسعة، وحتى ولادة المرء بعد التهجير خارج المخيم في أسرةٍ موسرة لم يكن ليمحو عنه وصمة اللجوء.
ولا تخبرنا رقية فقط عن حياة أهل المخيم، بل يزخر حديثها بتفاصيل كثيرةٍ من الثقافة الفلسطينية. كما نجد الكثير من الإحالات لرموز القضية، مثل ناجي العلي وحنظلة وأنيس الصايغ وغسان كنفاني وقصته أرض البرتقال الحزين، التي جاءت فيها عبارة «وعندما وصلنا صيدا، في العصر، صرنا لاجئين» التي استقرت في وجدان رقية.

لم تكن رقية من الناشطات السياسيات أو المهتمات بالتنظير رغم إدامنها للنشرات الإخبارية، ولكنها تحكي لنا بعضًا مما رأته من مقاومة الشباب والجموع التي كانت تحضر جنازات المغتالين أمثال غسان كنفاني، تنقلها لنا نقلًا سلبيًّا فلا تكاد تعلق حتى. وهو قرارٌ موفقٌ من الكاتبة، التي ظلت ترفض أن تشتت القارئ بأي قضايا أخرى، كالفقر والمرض والخلافات السياسية، سوى القضية الأصلية الأم. لأنّ تحت كلّ تراكمات الطبقات السياسية والجدلية ومن فعل ماذا أولًا، تقبع الحقيقة واضحةً ساطعةً سطوع الشمس، تأبى إلا أن يتفلت ضوءها من بين كلّ تلك الطبقات: هذه أرضٌ سلبت وشرّد أهلها عدوانًا وظلمًا. وهي حقيقةٌ لم يستطع حتى جنود إسرائيل الذين ولدوا ونموا على الأرض المسلوبة أن ينكروها، ولذلك نشأت حركاتٌ مثل حركة «رافض Refuser» التي يرفض الشباب الإسرائيليون فيها أداء الخدمة العسكرية الإلزامية ويفضلون قضاء فترة عقوبةٍ في السجن اعتراضًا على المشاركة في خدمة قوات الاحتلال، وحركة «كسر الصمت Breaking The Silence»، وهي حركةٌ أخرى أنشأها الجنود الإسرائيليون الذين تركوا الخدمة في جيش الاحتلال بعدما تبين لهم الحق، أي: بعدما تبين لهم أنّ كلّ ما تعلموه كان محض كذب، وأنهم محتلون، وأن هذه الأرض سلبت وشرد أهلها ظلمًا وعدوانًا. وأنا أنصحك، عزيزي القارئ، أن تطلع على بعضًا من تجاربهم في الروابط المرفقة بالمقالة، لأنّها تجارب إنسانيةٌ ثريةٌ للغاية تعلمنا الكثير، فليس من السهل أبدًا على إنسانٍ أن يعترف لنفسه حين يتبين له الحقّ أنه على الجانب الخطأ، وأن يكتسب الشجاعة بعد ذلك لمواجهة أهله وأصحابه بموقفه، فيتحول إلى خائنٍ وسط عشيرته بعدما كان بطلًا. ولأنّها أيضًا تؤكد لنا من منظور آخر ما نعرفه منذ البداية: أنّ هذه الأرض سلبت وشرد أهلها ظلمًا وعدوانًا.
للمزيد من المعلومات عن حركة «رافض Refuser»:
https://www.refuser.org/
للمزيد من المعلومات عن حركة «كسر الصمت Breaking The Silence»:
https://www.breakingthesilence.org.il/
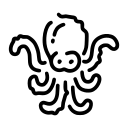

أحسنت 😘